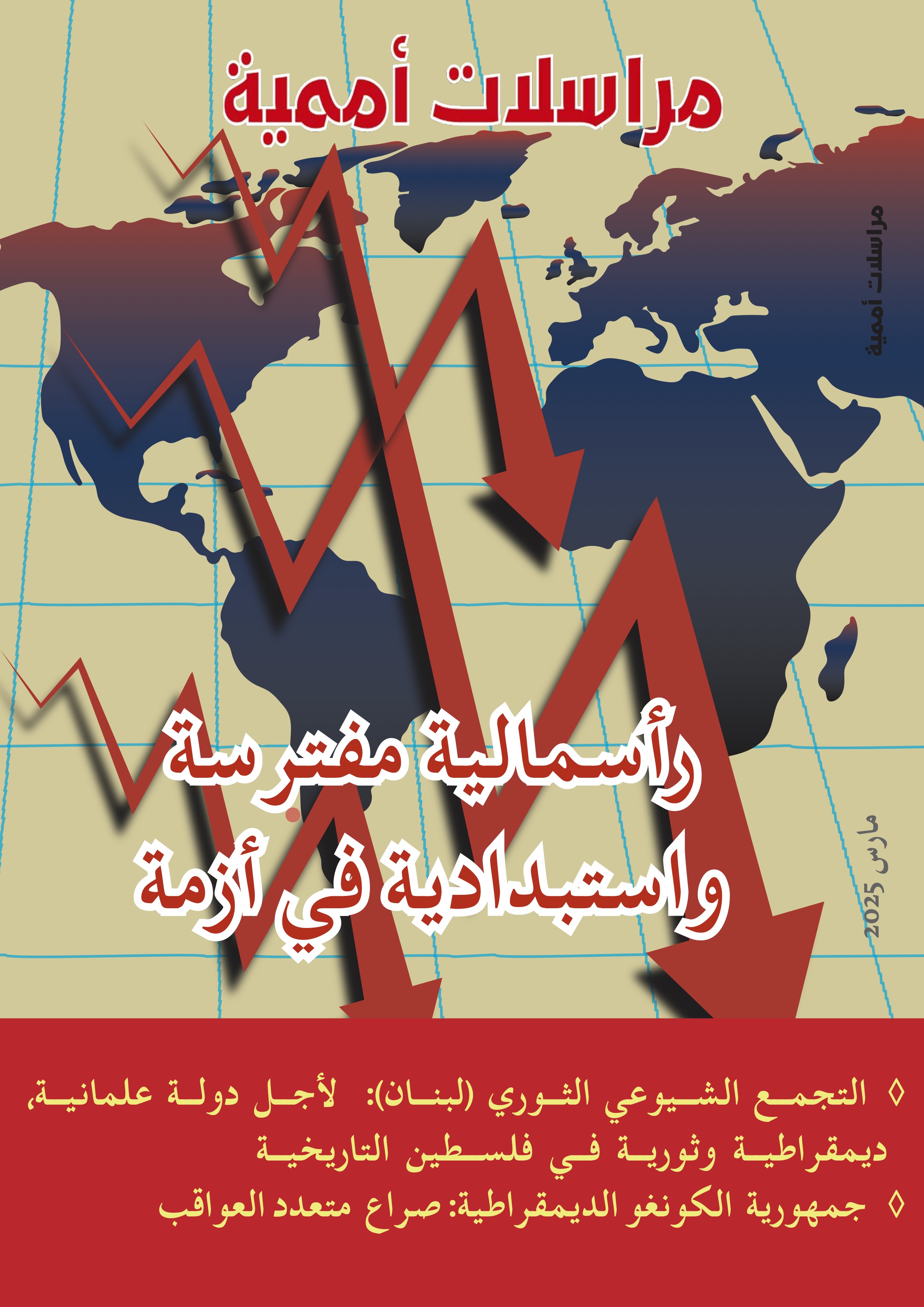الرأسمالية في أزمة عميقة، مع معدلات نمو منخفضة جدا. إنها أساس سياسات معادية للحقوق الاجتماعية بنحو حازم، ومتنامية الطابع الاستبدادي و الافتراسي، على غرار شهور رئاسة ترامب الأولى.
لما اتصلنا بك، كانت وضعُ أوروبا الاقتصادي نقطة بداية أسئلتنا. وبعد ذلك، أجبرنا وصول ترامب على النظر إلى الوضع بنحو أشمل بكثير.
يمكن فهم وضع أوروبا في سياق أشمل بكثير. تلك ميزة من مميزات عصرنا: لا تزال قوى قوية ذات نزعة مفكِّكة جدا داخل الرأسمالية، برغم تجاوز إطار حقبة عولمة وترابط جميع أشكال الرأسمالية. من الصعب للغاية فهم ديناميات كل منطقة بشكل منفصل.
ماذا يمكن القول عن وضع أوروبا الاقتصادي ونموها، أو بالأحرى عما تعانيه من شبه انحسار؟
دعونا ننظر إلى ديناميات النمو على أمد طويل، ثم نعود إلى ما يحدث الآن. شهدت العقود الخمسة الماضية تباطؤًا في النمو العالمي. بلغ متوسط معدل النمو العالمي في سنوات 1960، حسب البنك العالمي، نسبة 6.2% سنويًا. أما اليوم، فيناهز نسبة 3%. وتشير إحصائيات البنك العالمي إلى انخفاض معدل النمو العالمي إلى النصف في غضون خمسين سنة. ما يعني بشكل ملموس للغاية تراجع وتيرة التراكم الرأسمالي بنسبة النصف. يجب التأكيد على هذه المسألة التي لا يدور حولها نقاش إلا لماماً، لأن اليسار غالباً ما يركز على تنامي ثروات الطبقة الرأسمالية، في حين يُطمْئن اليمين ذاته باعتبار النمو مستمرا.
لكن الدينامية العميقة ديناميةُ تباطؤ نموٍّ، في البلدان المتقدمة وبوجه خاص في أوروبا الغربية. هو في هذه الأخيرة بنسبة 1% (إسبانيا حالة خاصة). انقسمت وتيرة النمو على 6، ما يعني تباطؤًا حادًا جدا ومتواصلا: انخفضت وتيرة النمو من 6% إلى 3-4%، أثناء الأزمة الأولى في سنوات 1970، وحدث تسارع طفيف في نهاية سنوات 1990، ثم انخفضت إلى زهاء 2% قبل أزمة العام 2008. تراوحت الوتيرة بين 0 و1%، منذ أزمة العام 2008، مع وجود اختلافات من بلد إلى آخر. كان العام 2017 آخر مرة تجاوز فيها النمو نسبة 2% في فرنسا، ويمثل العام الوحيد بين عامي 2008 و2024.
يعني هذا، والحالة هذه، مستويات نمو منخفضة تاريخيًا. إن نموا بنسبة 1% لاقتصاد مثل فرنسا حالة قريبة من الركود، وهذا أصح بالنظر إلى عدم بروز أية دينامية انتعاش اقتصادي، برغم ما أمكن من اعتقاد حدوث ذلك بعد الأزمة الصحية. لكن الناتج المحلي الإجمالي الفعلي الآن أدنى في معظم البلدان الغربية، وأوروبا الغربية بوجه خاص، من الميل القائم قبل الأزمة الصحية، بل وأقل بكثير مما كان عليه قبل أزمة 2008. أضحى في فرنسا أقل بنسبة 14% من الميل المسجل قبل العام 2008. وتبلغ الفجوة في بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديين OCDE نسبة 9.5%.
إن لهذه اللوحة أهمية بالغة، فمعناها أن كل الوعود المبنية على استئناف معدل النمو، وكل السياسات المعتمدة من أجل إعادة إطلاق النمو - سياسات القمع الاجتماعي وسياسات إسناد النشاط الاقتصادي وأشكال الدعم المباشر للقطاع الخاص والسياسات النقدية - لم تؤد في الواقع سوى إلى كبح التباطؤ، لكن لم توقفه.
يتسم الوضع في أوربا والحالة هذه بنمو بالغ الضعف، بما في ذلك الناتج المحلي الإجمالي للفرد - وهذا ينطبق حتى على إسبانيا، التي تشهد حاليًا معدل نمو بنسبة 3%، لكنها ظلت تعاني من ركود في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على مدار السنوات العشر الماضية. هكذا يظل خلق جوهري للقيمة غائباً.
نحن إذن في حالة شبه ركود، وبعض البلدان في حالة ركود بالفعل. تلك حال ألمانيا - أكبر اقتصاد في منطقة اليورو وثالث أكبر اقتصاد في العالم - التي تشهد حالة شبه ركود منذ العام 2018، أي منذ 7 سنوات. نما ناتجها المحلي الإجمالي الفعلي بنسبة 0.7% أثناء هذه الحقبة. و ذلك ثمرة تحول جوهري عام في الرأسمالية العالمية، وتتقدم الرأسمالية الأوربية هذا التباطؤ العالمي.
تحقق بعض الاقتصادات أداءً أفضل إلى حد ما، لاستفادتها من بعض المزايا. تتيح التكنولوجيات للولايات المتحدة الأمريكية حيازة قدر أكثر قليلا من القيمة، كما أن قوتها الإمبريالية تمنحها إمكان الوصول إلى الأسواق. وتستخدم الصين قوة دولتها للاستثمار في تكنولوجيات جديدة وبنى تحتية، ولا تزال تكاليف اليد العاملة فيها متدنية جدا. وتجمع بعض البلدان، مثل إندونيسيا، انخفاض تكاليف اليد العاملة ووجود مواد خام. لا تزال ثمة إذن مناطق نمو، لكن هذا الأخير غالبًا ما يكون غير كافٍ للبلدان المعنية، وتعاني مناطق أخرى نتيجة ذلك: وكأن حجم الكعكة لم يعد يكبر بسرعة كافية... ما يؤدي إلى مشاكل توزيع حصص.
يتسم هذا الوضع بحالة شبه ركود في ظل شبه انعدام آفاق نمو. ماذا يمكن أن تكون محركات النمو اليوم في أوروبا وفرنسا؟ لا يزال تأثير قطاع الصناعة ضعيفًا جدا في فرنسا، على عكس ما تصرح الحكومة. يتمركز هذا النشاط حول بعض القطاعات التي قد تؤدي إما إلى تعزيز الأرقام أو تقليصها. هناك قطاع النقل بسكك الحديد - تم بيع عدد قليل من قطارات فائقة السرعة TGV، لكن القطاع أصبح ذي طابع تنافسي بالغ، مع وجود الصين وإسبانيا وإيطاليا - أو بناء سفن عابرة للمحيطات، لكنه محدودًا جدًا، ويفضي أدنى تسليم سلعة إلى انتعاش اقتصادي يمنح الحكومة إمكان ادعاء نجاح سياستها. وفي قطاع الملاحة الجوية دينامية حقيقية، لكن مع ما نعرف من عواقب بيئية.
يتميز معظم اقتصاد فرنسا اليوم باعتماد 55% من حجم الاستهلاك و80% من حجم خدمات السوق في الغالب على استهلاك الأسر. تقوم الدولة بشراء النمو الضعيف جدا بواسطة إعانات، و تخفيضات ضريبية كثيفة - ما بين 160 و200 مليار سنوياً - لدعم عمليات تشغيل- وبالتالي قليل من إعادة توزيع القوة الشرائية – وخلق الاستثمار الذي لا يؤدي غالبًا إلى تحقيق مكاسب في الإنتاجية لاعتماد الاقتصاد على قطاع الخدمات. هنا يكمن العنصر الأساسي وهو عام في الرأسمالية المعاصرة لكنه ينطوي على إشكالية كبيرة بالنسبة لأوروبا: ينطوي تباطؤ النمو هذا على تباطؤ الإنتاجية.
ثمة طريقتان لتحقيق فائض القيمة: فائض القيمة النسبي و فائض القيمة المطلق1. إذا كان فائض القيمة النسبي ضعيفا، أي إذا لم تتزايد وتيرة الإنتاجية - تكاد تكون مكاسب الإنتاجية معدومة في فرنسا وألمانيا وإيطاليا - فإن الطريقة الوحيدة للحصول على فائض القيمة وإنتاجها إنما هي زيادة فائض القيمة المطلق، أي زيادة ساعات العمل، وتدهور ظروف العمل، وخفض أجر ساعة العمل، إلخ. يهدف شعار حكامنا المتمثل في «إعمل أكثر» إلى زيادة ساعات العمل.
لكن حتى ذلك لن يكون كافيًا، لأن مكاسب الإنتاجية المحققة ضئيلة جدا. تتمثل الحلول لتحقيق الربح، في تقديم الدولة المساعدات المباشرة، وافتراس الخدمات العامة، والافتراس عن طريق أنظمة ذات طابع ريعي (ذلك ما نراه، على سبيل المثال، مع التكنولوجيات التي تفرض دفع الفرد ثمن استعمال بياناته الخاصة) وأيضًا كل ما يسمى بالمرافق العامة utilities (الخدمات التي تقدمها البلديات، الماء، الكهرباء، الطاقة، إلخ). الريع هو تلك الممارسات التي قوامها بيع اشتراكات مقابل الحصول على أي شيء. إذ يجبرونكم على دفع ثمن أغراض لا ترغبون في شرائها، لأنهم يحاولون الالتفاف على اللجوء إلى السوق للوصول مباشرة إلى المال. يتمثل الهدف بنحو ما في الالتفاف على نظام إنتاج القيمة التقليدي لعجزه عن خلق فائض قيمة بما فيه الكفاية.
يؤدي تطور رأسمالية الريع هذه، وهذا الافتراس للدولة في اقتصادات مثل الاقتصادات الأوربية، المعتمدة بشكل كبير على التحويلات الاجتماعية والأجور في الآن ذاته، إلى إضعاف طلب الأسر وجعلها في حالة من انعدام الأمان. ترى هذه الأسر تنامي نفقاتها الإجبارية، فتتجه إلى ادخار احترازي وتقلص حجم استهلاكها «القابل للتحكم»، ما يؤدي بدوره إلى مزيد من انخفاض النمو، في إطار حلقة مفرغة.
تتسم الاستثمارات في الآن ذاته بالضعف بجودة رديئة جدا . إن الطفرة الاستثمارية المفترضة التي تشير إليها إحصاءات فرنسا بين عامي 2018 و2022 هي استثمارات صيانة بشكل حصري تقريبًا، دون تأثيرات دائمة. وهنا تكمن إحدى المشاكل الأساسية للرأسمالية المعاصرة: لم تسفر الثورة التكنولوجية التي حدثت ما بين سنوات 1980 وسنوات 2000 عن تحقيق مكاسب في الإنتاجية. عندما لا تخلق الاستثمارات إنتاجية، ينتهي الأمر إلى نفقات لا تنتج قيمة، ثم تصبحون مثقلين بالديون ولا تملكون حتى وسائل سدادها. هذا هو الوضع القائم الآن إلى حد ما، مع تطور ما نسميه «شركات الزومبي».
العنصر الثاني بالغ الأهمية، لا سيما فيما يتعلق بأوروبا، هو حالة الدين، سواء الدين العام أو الدين الخاص الذي تحدثنا عنه للتو. وبما أن الدين الخاص يمول استثمارات غير منتجة بالمعنى الفعلي للكلمة - أي أنها لا تُحسِّن مكاسب الإنتاجية أو لا تفعل ذلك بشكل كافٍ - فلا يمكن سدادها، وبالتالي يعمل الدين العام على دعم نشاط شبه زائف. كان هذا الأمر قائمًا منذ العام 2008، لكنه أصبح هائلًا مع الأزمة الصحية: إذ تم تطوير دعم غير مشروط وشامل للشركات - دعم حقيقي مباشر لمعدل أرباحها - وبات قسم من رأس المال معتمدًا على هذا الدعم. يحل هذا الدعم مكان إنتاج القيمة، ولا يعزز إنتاج القيمة.
وهو بالتالي لا يتيح مداخيل ضريبية جديدة. تصبح الإيرادات الضريبية والحالة هذه غير كافية لتغطية النفقات. و بهذا النحو، يرتفع الدين العام ويتزايد ضغط الأسواق المالية على البلدان الغربية، وبالأخص فرنسا. يؤدي ذلك هنا أيضا إلى ولوج حلقة مفرغة، مع تقشف يزيد كبح النمو.
ما نراه فشل ذريع للسياسات النيوليبرالية ولوعود النيوليبرالية بتحقيق فرص العمل والنمو عبر لبرلة سوق العمل. أدى ذلك في الواقع إلى إنتاج فرص عمل بأجور متدنية ومدعومة وغير منتجة إلى حد كبير. لا يمكن رفع الأجور بفرص عمل ضعيفة الإنتاجية. وعندما تواجهون ضغطاً على تحويلات الأموال من الدولة إلى القطاع الخاص، وضغطاً من الوضع الاقتصادي أو أي ضغط آخر من الأسواق المالية على الدين الخاص أو العام، يحصل الانهيار.
هكذا نكون إزاء فرص عمل ذات طابع هش، ليس بالمعنى المقصود بصفة عامة وحسب، بل أيضاً بنحو أساسي أكثر لأنها متوقفة على سياق تعاني فيه من مشكلة وجود مرتبطة بنقص مردودية. هذا على عكس الحقبة السابقة، حيث كان خلق فرص عمل صناعية يؤدي إلى إحداث فرص عمل عالية الإنتاجية، ما يضاعف حجم فائض القيمة. أما اليوم، ففائض القيمة المستخرج من كل فرصة عمل منخفض جدا، وبالتالي أصبحت جميع فرص العمل مدعومة من الدولة، ولذلك يشير حكامنا إلى ضرورة خفض ما يسمونه بالتكاليف - الأجور الاجتماعية، والضرائب - ويطالبون الدولة حتى بدفع جزء من الأجر! رأينا ذلك في أثناء الأزمة الصحية، عندما كانت الدول تدفع الأجور مباشرة.
تمثل أوروبا نموذجًا كاريكاتوريًا لهذا الوضع، لكن قد نجد هذه المشكلة في الولايات المتحدة الأمريكية، واليابان – حتى قبل الأزمة - وإلى حد ما في الصين...إنه عنصر مشترك للرأسمالية العالمية، رأسمالية ركود آخذة في التشكل. يشير اقتصاديون إلى أن وتائر النمو حالياً تفوق ما كانت في نهاية القرن التاسع عشر. لكن منذئذ، تسارعت وتيرة التراكم، وأصبحت العودة إلى الوراء تضعف كامل النظام المعد لتسريع وتيرة النمو بشكل دائم وليس لتخفيضها. يظل حلم الاقتصاديين الكلاسيكيين الجدد بـ «الهبوط بهدوء» مستحيلاً: لا يوجد توازن ممكن في النظام الرأسمالي، إذ أنه نظام هروب إلى أمام.
كانت إمكانية الافتراس الاستعماري قائمة في نهاية القرن التاسع عشر، وتطورت بسرعة كبيرة، لكنها لم تعد موجودة بنفس الطريقة اليوم.
تماما. شهدت نهاية القرن أزمة كبيرة بين عامي 1873 و1896. وكان رد الرأسمالية آنذاك قائماً على الافتراس الإمبريالي. لكن ذلك كان بموازاة ثورة تكنولوجية حقيقية، في نهاية سنوات 1890، باختراع محرك الاحتراق الداخلي والكهربة. استغرق تطور ذلك من 60 إلى 70 عامًا حتى انتشار الأسواق الجماهيرية.
تستمر الرأسمالية لأن ثمة في لحظة ما دفعة دينامية تعزز الإنتاجية بفعل تغيير تقني واحد أو عدة تغييرات متضافرة. كان ذلك حلم النيوليبراليين الكبير مع ظهور الحاسوب وإنترنت.
لكن ذلك لا يسير على ما يرام...
لو كان ذلك يسير على ما يرام، لحققنا مكاسب إنتاجية تعادل بالأقل تلك التي سجلت لحظة اعتماد الكهربة ومحرك الاحتراق الداخلي. قد لا تكون مكاسب إنتاجية على غرار نسبة 6 أو نسبة 7% المميزة لسنوات 1970، ولكن بالأقل نسبة 4 أو نسبة 5%. توجد حالياً مكاسب إنتاجية لكنها مقتصرة على قطاع الصناعة وهي بالأحرى ضئيلة. لكن المشكلة أنه نجد بالموازاة أن القطاعات الأقل إنتاجية هي الأسرع تطوراً، وبالتالي فإن مكاسب الإنتاجية الإجمالية آخذة في الانخفاض.
توجد تفسيرات عديدة ممكنة. يرى آرون بيناناف Aaron Benanav (L'Automatisation et le futur du travail الأتمتة ومستقبل العمل، Divergences، Quimperlé 2022) أنَّ هيمنة قطاع الخدمات (القطاع الثالث-م) بالتحديد يؤدي إلى هذه الانخفاضات في مكاسب الإنتاجية. ويميّز جايسون إ. سميث Jason E. Smith (هل يحلم الرأسماليون بأكباش كهربائية؟ Les capitalistes rêvent-ils de moutons électriques ?Éditions Grevis, Caen 2021) بين الخدمات المنتجة والخدمات غير المنتجة، ويضع انخفاض الإنتاجية هذا ضمن منطق تقلص إجمالي لمعدل الربح.
يمثل تطور الخدمات غير المنتجة هذا ردًا مباشرًا على ضعف النمو الشامل. عندما يتناقص النمو باطراد، يكون ثمة حلان ممكنان: مراقبة الزبائن والعمال من جهة، وما يسمي بمجال التداول (التسويق، الإشهار، إلخ) من جهة أخرى. إنها خدمات غير منتجة تمامًا ويتم تسديد كلفتها من الإنتاجية التي ستُحقق «بفضلها». وهي عبء على رأس المال وتؤدي في الواقع إلى انخفاض في الإنتاجية يحُث على زيادة تطوير هذه الخدمات.
يبقى السؤال المطروح، دون خوض في التفاصيل والنقاشات النظرية، هو ما إذا كان هذا الانخفاض ميلاً غالبا لا رجعة فيه أو - وأنا على علم بأنكما تحبان إرنست ماندل - ما إذا كنا في إطار موجة انحدارية طويلة وأن ابتكاراً تكنولوجياً (الذكاء الاصطناعي على سبيل المثال) أو عاملاً آخر ذا طابع اقتصادي بشكل غير مباشر قد يفضي إلى إعادة إطلاق مكاسب الإنتاجية على الصعيد الاقتصادي العام.
وهنا تساورني شكوك. لأنكم حتى لو قمتم بإحلال الذكاء الاصطناعي مكان مختصي القانون في الشركات أو مستشارين تجاريين وماليين، فإنكم تخالفون ما قطعته الرأسمالية من وعد متمثل في انتقال الأجراء/ات إلى مناصب عمل رفيعة المستوى، وتحول من يمارس عملا ذا طابع مُمكنن إلى الاشتغال في مكتب.واليوم، يتمثل المخرج الوحيد الذي يستطيع الرأسماليون اقتراحه بوجه التحديد في فرص عمل بطابع خدمات متدنية المستوى. وفضلا عن ذلك، من غير المرجح، على المستوى الاقتصادي البحت، تحقيق مكاسب إنتاجية كبيرة، نظراً لأن جميع فرص العمل هذه ليست منتجة في جوهرها. يكتسي ذلك العنصر أهمية لسعي الليبرتاريين libertariens والترامبيين trumpistes وما تبقى من النيوليبراليين إلى إقناعنا بأن للرأسمالية مستقبل.
كيف تحلل موجة التسريحات في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر الماضيين؟
الأمر بسيط للغاية: شهد معدل التشغيل زيادة كبيرة إلى حد ما، بعد كوفيد، لكن دون حدوث نمو، في إطار تدهور الإنتاجية. لا تكون فرص العمل هذه مستدامة إلا إذا شهد النمو تسارعًا في لحظة معينة. لقد تم خلق فرص العمل هذه بفضل الإعانات العامة، وموجة التضخم التي أتاحت في قطاعات كُثر- خاصة في قطاعات التوزيع- إمكان تعويض انخفاض أحجام المبيعات برفع الأسعار وبالتالي بزيادة هوامش أرباحها.
كان ثمة إذن إمكان تشغيل ما يفوق الحاجة من الناس، أجراء/ات لم يكونوا مطابقين للإنتاج بتاتاً. أراد بعض أرباب العمل الاستفادة من غنيمة الإعانات العامة لتحسين أداة الإنتاج مراهنين على تسارع الطلب في أعقاب الأزمة الصحية. كان قسم كبير من الناس في العام 2021 يعتقدون ذلك: كان معدل النمو 6%، وجرى تخيل عودة إلى السنوات المجنونة لما قبل قرن، وعلى حد تصريح برونو لومير Bruno Le Maire سيكون الوضع رائعاً. ينبغي عدم استبعاد إمكان تصديق الرأسماليين لخطابهم وبالتالي توقعهم حدوث نمو قوي. لكن هذا النمو القوي لم يتحقق قط، ولم يكن بد من إعادة توزيع الإعانات العامة لأسباب مرتبطة بالميزانية، كان الطلب ثابتًا تقريبًا، وأصبحت كل فرص العمل هذه عبئًا على المردودية.
كان ذلك تسريحات بمئات الآلاف في فرنسا...
إنه رقم ضخم، لكنه منطقي: كان هذا الإفراط في التشغيل شذوذا. إذ أن معدل البطالة المنخفض بشكل غير طبيعي قياساُ إلى النشاط الشامل في البلد أدى إلى انخفاض في إنتاجية البلد، ولا يمكن تحمل انخفاض الإنتاجية هذا إلا إذا شهدت السنوات التالية بالمقابل ارتفاعا معادلا أو أعلى في الإنتاجية. لا يحصل هذا الارتفاع، فتجري التسريحات من العمل وشكل من أشكال العودة إلى الوضع الطبيعي.
مع إعادة تنظيم اليد العاملة بالمناسبة، لأنهم قاموا بتشغيل شباب أصغر سناً، وها هم الآن سيطردون كبار السن من العمل...
أجل، إنهم يقومون بتسوية الأمور: يحذفون الأجور المرتفعة، ويحافظون على أكثر الأجور تدنيًا. يتمثل هاجسهم والحالة هذه في تحقيق فائض القيمة المطلق. وبالتالي ينبغي تشغيل أناس بأجور ساعة أدنى وبعقود عمل أشد هشاشة أو على أي حال أكثر مرونة. التشغيل اليوم ، بالنظر إلى إصلاحات قانون العمل الحاصلة، أسهل من تدبير من اشتغلوا بعقود عمل مضت عليها 20 أو 30 سنة.
تحدث عمليات التشغيل هذه في قطاعات الصناعة، والسيارات، والتجارة إلخ.
قطاع الصناعة أكثر تضررًا لأنه حظي بمساعدات ضخمة. كما تأثر قطاع التجارة سلباً أيضاً لأن الوضع كارثي: كانت مبيعات تجارة المفرق كارثية في العامين 2022-2023 وتحسنت بدرجة ضئيلة جدا في العام 2024، وبرزت جملة حالات إفلاس ولم ينته الأمر بعد. شهدت الأسواق التجارية العصرية الكبرى تشغيل يد عاملة بفضل ارتفاع الأسعار...لكن لهذا «التضخم القائم عبر الأرباح» حدوده، وقد اضطروا إلى التوقف عن الرهان على ذلك، لذا أصبحت أرباحهم الآن تحت الضغط. ثم شرعت الشركات في تقليص الطلبات المقدمة لمورديها، وبالتالي ستتأثر جميع الخدمات للشركات. لن تلجأ الأسر التي نالت منها البطالة إلى الخدمات الشخصية - رعاية الأطفال، إلخ – التي تُشكل فرص عمل كثيرة في فرنسا، الخ.
تعد فرنسا وألمانيا وإيطاليا أكثر المناطق الثلاث تضررًا، أليس كذلك؟
تضررت ألمانيا بشدة، فيما لا تزال في منتصف أزمتها ذات الأصل الصناعي. تختلف البنية الاقتصادية في ألمانيا تمامًا عن نظيرها في فرنسا: لا تزال نسبة قطاع الصناعة في ألمانيا ما بين 20 و25% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا يمثل نسيجاً اقتصادياً كاملاً. بدأت موجة تسريحات من العمل برغم عدم إغلاق شركة فولكسفاجن Volkswagen أي مصنع في آخر المطاف. فقد البلد 100000 فرصة عمل صناعي في عام واحد. الناس في ألمانيا قلقون جدا لأن نموذج البلد معتمد على الصناعة الراقية للغاية، تلك التي تحقق قدرا كبيرا من فائض القيمة والأجور المرتفعة التي تغذي بعد ذلك سائر البلد، وخاصة قطاعالخدمات.
حالة ألمانيا ذات طابع خاص لأنها أزمة مرتبطة باقتصاد الصين الذي ينتج سلع رفيعة الجودة وفاخرة. تفادت ألمانيا أزمة أوروبا طيلة فترة مديدة جداً لأنها كانت تزود الصين بالموارد التي تحتاج لتحقيق نموها، وخاصة الأدوات الآلية (وبالطبع السيارات الفاخرة). وعندما نظمت الصين خطة إنعاش اقتصادها بعد أزمة عام 2008 لإنقاذ الرأسمالية العالمية، بدأت الطلبات على الصناعة الألمانية في الازدهار مرة أخرى بسرعة كبيرة منذ منتصف العام 2009 لأنها كانت ترسل أدوات آلية إلى الصين.
المشكلة أن الصين في طور تغيير نموذجها الاقتصادي عبر الانتقال إلى مستوى أرقى. إذ تصنع سلعًا بسعر أرخص مما كانت تنتجه ألمانيا. كما أن جودتها بدأت تقترب باطراد من جودة منتجات ألمانيا، وبالتالي فإن سوق منتجات ألمانية آخذة في الزوال. والأكثر من ذلك، يأخذ منافسون صينيون حصة من سوق العالم، على سبيل المثال في مجال الطاقة الشمسية. كانت لدى ألمانيا صناعة مزدهرة في هذا المجال الأخير، لكن بعد ذلك بدأت الصين تبيع نفس السلعة بسعر أرخص واستحوذت على السوق بأكمله. تمارس الصين نوعًا من الإغراق: حيث تنتج بإفراط، وتخفض الأسعار إلى حد كبير جدا، ولا يستطيع الصناعيون الألمان مجاراتها، لأن الأسعار الصينية أقل بنسبة 30% مقابل نفس الجودة أو أقل منها بقليل. فوتت ألمانيا حقًا الفرصة تمامًا واكتفت بابتكارات على الهامش لتثبيت تبرير أسعار مرتفعة. وفضلا عن ذلك، شهدت فترة ما بين عامي 1997 و2013 إغراقًا ألمانيًا في الأجور - ركودًا في الأجور - قضى تمامًا على جميع المنافسين الأوربيين، ووجدوا أنفسهم بوجه صناعيين صينيين لم يكن أمامهم سوى الصناعة الألمانية كمصدر ممكن للموردين. انتهى كل شيء الآن. وأبرز مثال على ذلك هو السيارة الكهربائية: بينما كان الصناعيون الألمان يسعون إلى التلاعب في اختبارات محركات الديزل، كانت دولة الصين تدعم السيارات الكهربائية - وعندما أصبحت السيارة الكهربائية منتوجاً جماهيريا، لم يكن الألمان جاهزين مطلقاً.
للحديث عن إرنست ماندل مرة أخرى، صحيح أننا عادة ما نعتبر العودة إلى موجة نمو مديدة مرتبطةً بعوامل خارجية، إما اكتشافات تكنولوجية كبرى أو عوامل سياسية خارجية... وهذا يغير مجريات الأمور، لكن كيف تحللون مبادرات ترامب والرسوم الجمركية والرغبة في عمليات ضم مناطق وهجماته على جهاز الدولة؟
هذا هو السؤال الحقيقي. لكي نكون في هذا المجال النظري إلى حد ما ونربطه بترامب: إذا كنا إزاء نظام موجة طويلة، وكنا في قاع الموجة، يقتضي السير بسرعة حربا، ثم يليها صعود لأنه لا بد من إعادة بناء. لكن المشكلة تكمن في أن الميل الحالي متجه نحو إضعاف طويل الأمد، ما يعني أنه حتى لو عادت العوامل الخارجية - أو الداخلية - إلى التحرك مرة أخرى، فإن الدينامية الداخلية للرأسمالية أصبحت ضعيفة جدا لدرجة أنني لست متأكدًا من القدرة على العودة إلى مستوى عالٍ جدًا. وهذا ما لمسناه في نهاية المطاف أثناء الأزمة الصحية، على الرغم من الحفاظ على أداة الإنتاج. كان تدارك التأخر سريعا ثم أصبحت الميول نحو الإضعاف كبيرة مرة أخرى.
يطرح هذا أكثر المشكلة السياسية: فحتى الذين لديهم أفكار حول كيفية صون وتيرة التراكم سيواجهون في كل الأحوال ميلاً أساسياً قوياً يجذب التراكم نحو الانخفاض. ستشهد أوكرانيا على سبيل المثال إعادة إعمار بعد الحرب، وسيرتفع ناتجها المحلي الإجمالي عاليا، وهذا منطقي. غير أن أوكرانيا إذا أصبحت في الواقع مكانًا لإنتاج رخيص الثمن في أوربا الغربية، فستحل مكان بلد آخر. إنه منطق الكعكة التي لم يعد حجمها يزداد.
أعادت الحرب العالمية الثانية إطلاق سير الرأسمالية، حيث كان هناك أيضًا تغيير تكنولوجي وتغيير كبير في نطاق الإنتاج، أي الثورة الصناعية الثانية، التي كان مطلوبا نشرها. أدت الحرب إلى تسريع هذا الانتشار. وأيضا بسبب وجود إمكان تطور اﻻستهلاك الجماهيري، الذي بدأ في نهاية القرن التاسع عشر لكن لم يتطور بالفعل إلا بعد الحرب العالمية الثانية، ﻷسباب سياسية إلى حد كبير.
توجد هنا ديناميات داخلية لرأس المال، وأتاحت الدينامية الخارجية إمكان إقلاع الوضع برمته مرة أخرى. اليوم حتى هذا غير موجود، لا: ثمة شيء من قبيل ميل معدل الربح إلى الانخفاض، وهو أمر مرتبط بمسألة الإنتاجية. في لحظة ما ثمة قوة تجذب هذه الإنتاجية إلى أسفل، وهو ما نسميه بالتركيب العضوي لرأس المال: بلغتم مستوى معيناً من الإنتاجية حين يصبح رأسمالكم باهظ الكلفة ولم تعد المكاسب التي تحققونها تتيح لكم كسب فائض قيمة كافٍ. تتراجع أهمية الاستثمار المنتج وتتمثل الطريقة الوحيدة لتحقيق النمو في زيادة فائض القيمة المطلق.
نسمع في الولايات المتحدة الأمريكية أن معدل نموها البالغ نسبة 2.5% رائع، لكنه لا يصل إلى ما كان في سنوات 1950-1960 أو حتى 1980. وبالمثل، يبلغ معدل النمو في إسبانيا نسبة 3%، لكنه كان 4% أو 5% في سنوات 2000. وتخبرنا حكومتنا بأننا سنكون أبطالا عندما نحقق نسبة 0.8% من النمو، الخ.
أعتقد أن قسماً كبيراً من رأس المال، وحتى كله، مدرك لهذا الوضع، لذلك أرى أننا قيد التخلي عن النيوليبرالية. أدركوا أن تطوير الأسواق ولبْرلتها لا يجدي نفعًا. قد يُستخدم لتطوير بعض السياسات العامة المبررة بالحجج القديمة - إصلاح نظام التقاعد، وأشكال اللبرلة المرتقبة في سوق العمل، الخ. - لكن ذلك لم يعد جوهر المشكلة.
جوهر المشكلة مزدوج في الواقع. فمن ناحية، يعتمد قسم من رأس المال اليوم - وخاصة رأس المال المنتج وخدمات السوق وصناعات كثيرة - على إعانات الدولة المباشرة - إعانات وتخفيضات ضريبية إلخ. إذا ألغيت هذه المساعدات، لن يتبقى لهم أي شيء، ولن يحققوا أرباحا، ولن يحدث أي نشاط. وهذا صحيح في الصين أيضًا، لأننا في ظل شبه أزمة فيض إنتاج صناعي.
ومن ناحية أخرى، توجد إستراتيجية مغايرة مفادها إننا سنقوم، نظرا لصعوبة إنتاج القيمة بطريقة تقليدية عبر العمل، بالالتفاف على هذا النظام وإنتاج القيمة عبر الريع. يستهدف قطاع بأكمله نظام الريع هذا، نظام افتراس الموارد والأسواق في الآن ذاته. يبدو ذلك رائعاً بالنسبة لرأسمالي فردي: بوسعكم تحمل جميع أشكال هبوط معدل الأرباح الإجمالي إذا كان ربحكم الشخصي مرهوناً بمجرد اضطرار الناس إلى الدفع لكم ليتمكنوا من العيش بشكل طبيعي. هذا انخداع في الواقع، لأن هذا المال نفسه متوقف على معدل الأرباح الإجمالي. لكنه وهم قوي في هذه القطاعات.
لا يُعد ذلك تقسيمًا دقيقًا، فبعض القطاعات - مثل قطاع التمويل - لها موطئ قدم داخل نظام الإنتاج وآخر خارجه، لأن القروض تعتمد بشكل واضح على النشاط الاقتصادي، لكن جزءًا من التمويل منفصل تمامًا عن نظام الإنتاج. وبالتالي، تبرز بشكل عام هاتان الإستراتيجيتان.
ما التنظير السياسي لهاتين الإستراتيجيتين؟ الترجمة السياسية، بالنسبة للقطاعات المنتجة، هي دولة تدمر الدولة الاجتماعية وظروف العمل في الآن ذاته للحصول على أكبر قدر ممكن من الموارد لدعم القطاع الخاص. ما يستتبعُ اعتمادَ سياسة تقشف اجتماعي وسياسة تحويلات مالية - كما شهدنا مع كوفيد: «سياسة ضمان اجتماعي لأرباح الشركات».
أما بالنسبة للقطاعات الريعية، فلا يهمها الحصول على مساعدة الدولة، لأنها اليوم في مستويات دولانية، وبالتالي منافسةٍ للدول. إن شركات التكنولوجيا الكبرى والشركات الاستخراجية الكبرى في منافسة مع الدولة التي تعيق تطورهما: على الشركة الحصول على حقوق الحفر عندما تكون مختصة في قطاع النفط، وثمة مشاكل تنظيمية عندما تكون مختصة في مجال التكنولوجيا... تتمثل الفكرة والحالة هذه في تفريغ الدولة من محتواها، والإبقاء وعلى الحد الأدنى من الحاجة فقط، وإحلال الشركات مكان الدولة. هذا هو نظام الدولة الحارسة minarchique [دولة الحد الأدنى] أو النظام الرأسمالي اللاسلطويanarcho-capitaliste، الذي يستعيض عن الدولة بشركات تحقق أرباحا وتحل مكان مهامهما الرئيسية. هذا بالضبط ما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية: يصل إيلون ماسك Elon Musk مع هؤلاء الشباب من وادي السيليكون Silicon Valley الواثقين بأنفسهم بدون أية خبرة سوى التي اكتسبوا من شركات الريع، ويستولون على الدولة الأمريكية ويجرّدونها من كل شيء ليحتفظوا فقط بما يهم رأس المال الريعي.
ومع ذلك، هناك أوجه التقاء بين الإستراتيجيتين الرئيسيتين: التخفيضات الضريبية، وتدمير الدولة الاجتماعية وأنظمة الحماية للعمال... وبعبارة أخرى، القمع الاجتماعي.
ثمة والحالة هذه شكل من أشكال تسارع الظاهرة النيوليبرالية، لكن أيضا حالة هروب إلى أمام: لتعويض استمرار ضعف النمو هذا، سيتم نهب الدولة. وهذا إشكالي بالنسبة للشركات الصناعية، إذ أن عدم وجود تحويلات من الدولة يعني مواجهة مشكلة في القدرة على البقاء. وهو أيضا مشكلة تبعية إزاء القطاعات الريعية، لأن الشركات الصناعية تعتمد على شركات التكنولوجيا وشركات الإمداد بالكهرباء والمياه إلخ، وبالتالي تصبح نوعاً من القطاع الفرعي.
مشكلة هذه المنافسة داخل رأس المال قد تجد حلا في بعض الحالات بواسطة القمع الاجتماعي، الذي يناسب قليلا الجميع - وتلك سياسة ماكرون اليوم إلى حد ما: الإبقاء على المساعدات للشركات عبر ممارسة القمع الاجتماعي. وإجمالا، تظل الشركات الريعية راضية بسبب عدم زيادة الضرائب. يمكن حدوث ذلك في فرنسا لأن اقتصاد فرنسا يقوم بشكل أساسي على قطاع الخدمات التجارية، ولا وجود فيه لشركات تكنولوجيا عملاقة. لكن الوضع مختلف نوعًا ما في الولايات المتحدة الأمريكية: بفعل مكانة عمالقة التكنولوجيا في النموذج الاقتصادي الأمريكي، سيندلع نزاع أقوى بكثير بين الطرفين. قد تحاول السياسة الحمائية إيجاد تسوية داخل رأس المال، لكن لدى بعض شركات التكنولوجيا الكبرى ما تخسره في هذا الصدد...
يفرضها ترامب بيد، ويلغيها بيد أخرى...
القراءة الأولى هي أن هذه الرسوم الجمركية ليست سوى نزعة حمائية كلاسيكية دفاعاً عن رأس المال الوطني بأكمله ضد الرساميل الأجنبية، بغية إعادة توطين الإنتاج في الولايات المتحدة الأمريكية. تخفض الدولة الضرائب بفضل عائدات الرسوم الجمركية، ويصبح الجميع مسرورا داخل البلد. هذا ما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية في الطور الأول من تطورها بعد حربها الأهلية: تطورت الولايات المتحدة الأمريكية محمية بفرض الرسوم الجمركية الهائلة، وهذا ما يعتمده ترامب مرجعاً.
تكمن مشكلة هذه الفرضية في وجود تناقض في التعابير. ينبغي على الرسوم الجمركية ردع حركة الواردات إلى الولايات المتحدة الأمريكية. لكن ترامب سيخفض الضرائب بفضل عائدات الرسوم الجمركية. وبالتالي، إذا حدثت عملية إعادة توطين وحدات الإنتاج، ستنخفض عائدات الرسوم الجمركية، وسيتعذر تمويل عملية تخفيض الضرائب. وعلاوة على ذلك، يجب أن تكون الرسوم الجمركية مرتفعة بما يكفي لتعويض الفوارق في تكاليف اليد العاملة بغية إعادة توطين وحدات الإنتاج. يبلغ الفرق اليوم بين عامل في المكسيك وآخر في الولايات المتحدة الأمريكية ما بين نسبة 1% ونسبة 6%، وليس 25%. وبالتالي ستشهد الأسعار ارتفاعًا إذا حدثت إعادة التوطين. سترتفع الأجور لأن سوق العمل في الولايات المتحدة الأمريكية يعاني أصلا من ضيق، وبالتالي سيحدث ضغط على معدل أرباح الشركات الصناعية لا يمكنها تحمله بالضرورة في وضعها الحالي، وسيؤدي ذلك إلى زيادة في الأسعار ستكون أكبر بكثير من نسبة 25% في زيادة الرسوم الجمركية...
لا ينبغي استبعاد هذه الفرضية الأولى كلياً، إذ قد تكون هي مشروع ترامب. سنكون حينها أمام خطة كالتي اعتمدها ماكرون: محاولة تحقيق السلم داخل رأس المال عبر العمل في نفس الوقت على حماية الصناعيين ومنح رأس المال الريعي ما يبتغيه من تخفيضات ضريبية. لكن ذلك محكوم بالفشل.
الفرضية الثانية هي أن هذه الخيارات ذا طابع سياسي في الواقع. لدى الولايات المتحدة الأمريكية مشكلة، إذ يقوم نموذجها الاقتصادي على اقتصاد خدمات تجارية بنسبة 80%، مع وجود قطاع تكنولوجي فائق التطور ومربح للغاية وقوي جدًا ومتقدم على جميع القطاعات الأخرى. وهذا النموذج الاقتصادي جزء صغير من الاقتصاد الأمريكي، لكنه جزء بالغ الأهمية لأنه ينتج قيمة ضخمة للغاية. تتجلى المشكلة في أن الصين قيد اللحاق بها اليوم - كما رأينا في مجال الذكاء الاصطناعي.
أود الإشارة جانبًا باختصار إلى فكرة مهمة على ما أعتقد: كانت الفكرة الرائجة منذ سنوات (خاصة من قبل أنصار ماكرون) هي أن الابتكار في حاجة إلى تخفيضات ضريبية لفائدة أرباب الشركات، وإلى مجاملتهم، والى عدم صرف أجور عالية للناس، والى تقديم مساعدات عامة لهم، وتأمين طلبيات لهم، الخ. لكن في الواقع، هذا خاطئ كليا: الابتكار يكون تحت ضغط الاكراهات، وعند اعتراض عوائق يكون البحث عن حل. هذا بالضبط ما حدث في الصين: قال الباحثون: «لا نملك معالجات دقيقة microprocesseurs، فلا يمكن اعتماد هذه الإستراتيجية (وهي إستراتيجية مجنونة أيضاً على المستوى البيئي، والتي تتمثل في زيادة القدرات الحاسوبية) وبالتالي سنجد حلاً للاكتفاء بما عندنا». يتمثل كابوس الأمريكيين في قدرة الصينيين اليوم على الابتكار بكلفة أقل وبجودة مماثلة تقريباً، وبالتالي سيأخذون الأسواق منهم في كل مكان، حتى في مجال الذكاء الاصطناعي.
كانت إستراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية لإدامة هيمنتا متمثلة حتى اليوم في الانتشار في كل مكان تقريبا، مع الحرب على العراق وأفغانستان، وقوات في أوروبا، الخ. أما اليوم فتكمن في بناء إمبراطورية حقيقية، أي بشبكات أتباع سيأتون لاستهلاك منتجاتها، خاصة منتجاتها التكنولوجية أو نفطها أو غازها المسال. ولن يكون أمامهم خيار.
يعيدنا هذا إلى ما قلته عن الريع: رهان قسم من الرأسمالية الأمريكية اليوم هو تفادي المنافسة، وبالتالي ليس بناء سوق ضخمة عابرة للمحيطين الأطلسي والهادئ كما كان الحال في أيام النيوليبرالية، بل إمبراطورية: مركز وأطراف، لكل منها دور إزاء المركز. وبالطبع، ليس هذا هو الحال اليوم: تعقد أوروبا اتفاقات تبادل حر مع بلدان أخرى. لكن إذا كان هدف الولايات المتحدة الأمريكية أن يشتغل كل بلد في خدمة المتروبول، قلب الإمبراطورية، فالرسوم الجمركية وسيلة لممارسة الضغط. وهذا ما يفسر لعبة ترامب الحالية: يفرضها ثم يسحبها. وعندما يسحبها، يُقال إنه مهرج. قد يكون مهرجًا، لكنه يبعث الرسالة إلى المكسيكيين والكنديين: بوسعي سحبها، لكن يجب طبعا قبول شروط، وإلا سأفرضها مرة أخرى. تتمثل هذه الشروط في ولوج الأسواق، على سبيل المثال في أوروبا. نعلم جيدا ما يريد: إلغاء كل تقنين للتكنولوجيا، واحتكار الغاز المسال، وولوج سوق الصناعات الحربية (وبالتالي عندما يقول علينا تخصيص نسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع، فهذا يعني الشراء من الولايات المتحدة الأمريكية)... بل يمكن حتى تخيل أنها تجعل كل رأس المال الأمريكي متفقا عندما تقول لمحيطه: لدينا منتجات صناعية نريد بيعها، وستنضمون إلى سلسلتنا اللوجيستية وفق شروطنا.
وسيكون للرسوم الجمركية آنذاك دور الضغط على بلدان أطراف الإمبراطورية لإخضاعها أكثر. قد يبدو هذا الأمر مناقضا كليا للسليقة، لكنه في الواقع يستهدف الحلفاء قبل الأعداء، لأنه قيد إنشاء تكتل إمبراطوري، وعندما يتشكل هذا الأخير سيكون بوسعه مواجهة الصين (الصين بصدد القيام بنفس الشيء تمامًا، بأشكال أقل عنفًا وأقل تهريجا بواسطة «طرق الحرير الجديدة»، التي تمثل أشكالًا من النفوذ والتبعية للديون). لكن ذلك أيضا محفوف جدا بمخاطر: قد يؤدي تأثير هذه الرسوم الجمركية على النمو المكسيكي أو الكولومبي إلى سعي المكسيك وكولومبيا للحصول على دعم الصين على سبيل المثال... لكن إذا رسخت الصين أقدامها في المكسيك أو في كولومبيا، يغدو الأمر خطيرًا جدا. لذا يجب عدم استبعاد الطابع الخطير للشخص أيضًا...
كيف تفسر نشر صحيفة «وول ستريت جورنال» افتتاحية عدوانية جدا ضد خيار ترامب بشأن الرسوم - فهي بكل حال صحيفة رأس المال المالي - وهبوط مؤشر داو جونز Dow Jones ردًا على هذه التصريحات؟
نعود إلى نقاشنا السابق: إننا إزاء أشخاص يبذلون كل ما في الوسع لتأمين معدل أرباحهم، لكنهم يصطدمون بتناقضات دائمة. يواجه ايلون ماسك واقع ترحيل قسم من إنتاجه إلى الصين، وأهمية سوق الصين بالنسبة له، ما يسبب انخفاض سعر سهم شركة تسلا Tesla. كانت الرأسمالية الأمريكية مهيكلة بوجه التحديد حول المكسيك وتوريد المنتجات المكسيكية، بإيعاز من ترامب في أواخر سنوات 2000- لكن سلسلة التوريد للرأسمالية الصناعية الأمريكية، أصبحت اليوم مهددة بالتوقف تمامًا، بسبب الرسوم الجمركية. هذا ليس منطقيًا، وفي الواقع يبين رد فعل صحيفة وول ستريت جورنال أن هذه الدوائر تواجه تناقضًا من وجهة النظر هذه. لكن ذلك ما يفسر أيضًا كون الأمر سياسياً جدا. لو كان خيارا اقتصاديا صرفا، لكان وعد ترامب بتعويض خسائر وول ستريت عبر ضمان نمو متسارع، وعدًا ذا مصداقية. لكن الوعد الحقيقي متمثل بالفعل في إنشاء إمبراطورية ممركزة لا تزال مكاسبها الاقتصادية غير مؤكدة.
تمثل الدولة المصالح الجماعية للبرجوازية لأن هذه الأخيرة لا تستطيع، بما هي مجرد مجموع رساميل، التعبير عن مصالحها الجماعية...
بالضبط. ثم عندما تتباين مصالح القطاعات (ولم أشر سوى إلى سمتين رئيسيين متناقضين، لكن في الواقع هناك عشرات المصالح المتباينة داخل القطاعات) - كما هو الحال اليوم - فإن المهم هو أن هذه المصالح المتباينة تعكس أيضًا هذه التناقضات، أي حدود مقدرتها اليوم على مواجهة ميل المردودية الأساسي نحو الانخفاض.
يتيح أيضاً وجود شخص مجنون على رأس الدولة اتخاذ قرارات جذرية، حتى لو أن قسمًا من البرجوازية لا يعتبرها ملائمة في لحطة ما. الأمر يتطلب بعض الجرأة...
يسعى القسم الأعظم من الخطاب الرأسمالي السائد إلى حجب خطورة الوضع عنّا وإيهامنا بانعدام بديل. لكن الوضع حرج جدا لدرجة عجزهم عن محاولة الفكاك منه نه إلا باتخاذ قرارات جذرية ستنجم عنها عواقبها على بعض أفراد طبقتهم. ثمة وجه يأس، وهذا أيضا من أعراض أزمة النظام الرأسمالي...
هذا فضلاً عن الأزمة الإيكولوجية...
أعتقد أننّا نشهد أزمة نظام رأسمالي لأن النيويبرالية التي كانت نمط تدبير الرأسمالية حتى الآن باتت مستنفذة، وبالتالي ينبغي إيجاد نمط تدبير جديد ونمط هيمنة جديد. هنا تحل الإمبراطورية مكان السوق، وقد لا تسير الأمور على ما يرام. ثمة دوماَ في حقب الأزمة بحث بالتلمس: شهدت أزمة العام 1929 حمائية لم تكن مجدية، ثم جاءت اجراءات نيو ديل New Deal التي شهدت في الواقع ثلاثة أطوار: بعد أوجه تقدم وتوقفات، أدت أزمة جديدة إلى فكرة أن الحل الوحيد قائم في إنتاج الدبابات...
فترات الأزمة مطبوعة بكثير من الارتباك بسبب محاولة إيجاد حلول، لكن هذه الأخيرة لا تثبت فعاليتها دوماً، وتبوء أحياناً بفشل ذريع. نظراً لعدم وجود نظام آخر غير الرأسمالية، وحدهم الرأسماليون يجربون أمورا. لكن إذا شرع العمال مثلا، في عالم مثالي، في تجريب أمور، فلن يتحقق كل شيء بين عشية وضحاها، إذ ستكون ثمة إخفاقات، وتراجعات، وأوجه تقدم...
خصوصية الأزمة الراهنة، الحقيقية برأيي، هي في تعدد أوجهها: ثمة هذه الأزمة الاقتصادية التي كثر الحديث عنها، ولكنها - كما قلتم - انضافت في الواقع إلى أزمة بيئية ناجمة عن نمط الإنتاج. سيتخلى ترامب، كما يبدو جليًا، عن كل التنازلات الضئيلة المقدّمة إلى الإيكولوجيا والنظام البيئي، في محاولة لإنقاذ رأس المال.
يقول مارتن لالانا سانتوس Martin Lallana Santos في مقال بعنوان «الإستراتيجية الاشتراكية الإيكولوجية في الفترات المضطربة» Stratégie écosocialiste en période de turbulences إن تجاوز أزمة الرأسمالية يقتضي عامة زيادة إنتاج الطاقة بعشرة أضعاف... [ انظر مجلة إنبريكور عدد 729].
طبعاً. لكن لا ننسى مرة أخرى أن مرجع ترامب هو متم القرن التاسع عشر: آبار النفط في كل مكان. الأكيد أنه سينسف المعايير البيئية، وليس في الولايات المتحدة الأمريكية وحسب. سيمارس ضغوطًا لبلوغ نفس الشيء في أوربا وأمريكا اللاتينية وجميع البلدان المعتمدة على الولايات المتحدة الأمريكية. وقد بدأ قادة أوروبا بالفعل يقولون بأنهم أفرطوا في السير بعيد جدًا، وأن هناك معايير أكثر من اللازم. لكن ما يدور في الخلف في الواقع هو تدمير البيئة، لأنه يجب ألا ننسى أن أزمة البيئة لا تقتصر على الاحتباس الحراري بل تطال أيضًا التنوع الحيوي وبقاء نوعنا على قيد الحياة. أزمة البيئة عرضة لإِنْكار لأن التراكم يحظى بالأولوية.
ثمة أيضًا الأزمة الاجتماعية والمجتمعية والأنثروبولوجية. لا تأتي الموجة الرجعية من عدم. إنما تنبع من كون المجتمع الرأسمالي مريضا بما أنتجه، أي فرط الاستهلاك، الذي لا تقتصر عواقبه الوخيمة على البيئة وحسب، بل أيضًا على الكائنات البشرية التي تعاني من الإفقار الدائم بسبب فرط الاستهلاك هذا: كلما زاد الاستهلاك، زاد النقص إلى شيء ما. ما شهدنا مع أزمة التضخم بالغ الأهمية من وجهة النظر هذه. إن شعور الحرمان من مقدرة مواكبة هذا الجنون الاستهلاكي الدائم يجعل الناس تعساء ومذعورين. يتحقق النمو في الولايات المتحدة الأمريكية بزيادة أشكال الريع، وبالتالي بتنامي حجم النفقات الالزامية خاصة في مجال الصحة. إن تسليع الصحة دليل على تنافر النمو والرفاهية. وهذا عنصر حدد جزئيًا نتائج الانتخابات الأمريكية: خاض الديمقراطيون حملة الانتخابات مستندين على نمو بنسبة 3%، وكان بول كروغمان Paul Krugman يشرح لنا، كل أسبوع، في صحيفة نيويورك تايمز أن الولايات المتحدة الأمريكية مزدهرة للغاية ولا داعي للتذمر... لكن كان على الناس مواجهة تلك النفقات الالزامية المتزايدة.
وبصورة أعم، الحث على الاستهلاك غير مقنع أساسًا. ويمثل ترامب تعبيراً عن السعي إلى تأمين نمط حياة لا يمكن الدفاع عنه بوعد زائف بأنه ضمانة للسعادة.
تمكنت الرأسمالية الغربية على مدى فترة طويلة من قول إن مستوى المعيشة يرتفع ونوعية الحياة تتحسن لأن بوسع الإنتاج التركيز على تلبية حاجات بديهية. ثم، في نهاية سنوات 1960 أو بداية سنوات 1970، لما تحققت تقريبا تلبية جميع حاجات الناس الأساسية، وحتى أكثر بقليل، لم يكن بد مع ذلك من الاستمرار في بيع سلع. تلك هي اللحظة التي يخلق فيها رأس المال حاجات الأفراد لإعادة إنتاج نفسه. تتحدد حاجات الأفراد والحالة هذه بشكل دائم وفقاً لحاجات رأس المال. مما يسبب في الآن ذاته رغبة مستمرة وشعور حرمان وعزلة عميقة. المجتمعات ليست بخير، حتى عندما يظل معدل النمو صامداً، وربما في هذه الحالة بوجه خاص! يندرج هذا، بنظري ، في إطار الأزمة الشاملة، انه قطب ثالث من أقطاب الأزمة.
ثمة شيء ما باعث على اليأس: عند سعي إلى معالجة أحد أقطاب الأزمة، يتفاقم القطبان الآخران. عند محاولة حل الأزمة الاقتصادية، كما يفعل ترامب وقادة أوربا الآخرون، تُفاقم أزمة البيئة عشرة أضعاف، وتُضاعف الحاجات التكنولوجية لجعل الناس أكثر تبعية وأكثر إصابة بمزيد من التوتر العصبي... هل تحاولون حل أزمة البيئة؟ إذن يمكن أن تنسوا نموكم وتراكم رساميلكم. هل تسعون لحل الأزمة الاجتماعية؟ تضعون حدًا للاستهلاك الجماهيري... تقعون بالفعل في نوع من مأزق مستمر، وهذا كله مرتبط بواقع مركزي: المجتمع خاضع لضرورة تراكم رأس المال، وبالتالي تابعًا لمهرّجين يصنعهم لنا رأس المال: أمثال ترامب، وماكرون، الخ.
هذا يعزز بكل حال اقتناعي أننا دخلنا - على حد تعبير توم توماس Tom Thomas - طور شيخوخة الرأسمالية: نحن في نظام يسير بشكل سيء باطراد، لكنه مستمر لأنه يقيدنا في دائرة خيارات مستحيلة. يتصور الناس نهاية العالم أكثر من تصورهم نهاية الرأسمالية...
شهدنا انحطاط أنظمة اجتماعية في ماضي البشرية - روما بالطبع، وأيضًا جمهورية النبلاء البولندية في ما بين القرنين السادس عشر والثامن عشر - لكنه كان متمركزًا كل مرة في منطقة ما. نعاين وجود نظام معولم بالفعل، الرأسمالية قائمة في كل مكان، حتى لو كانت أنظمتها السياسية مختلفة إلى حد ما. كما نلاحظ تزايد ميل الليبرالية إلى ممارسة الاضطهاد ، وتناقص الديمقراطية، ونظام الصين، الذي ليس نظامًا ديمقراطيًا ولم يكنه قط. توجد رساميل تتعدى حدود الدولة في هذا الوضع، وحروب بعيدة عن كونها محلية وحسب - أوكرانيا، فلسطين/إسرائيل، الكونغو - لكنها ليست مواجهة معممة حالياً. هل تعتقد إمكان السير نحو مواجهة معممة للخروج من التناقضات؟
أود العودة إلى أمرين فيما قلتما. الأول، المهم، هو نهاية الرأسمالية الديمقراطية. اعتدنا لفترة طويلة سماع أن الديمقراطية في حاجة إلى الرأسمالية ولا يمكن تصور إحداهما دون الأخرى. لكن التاريخ علّمنا أن الرأسمالية والديمقراطية ليسا نفس الشيء بتاتاً، بل إنهما متناقضتان أحياناً. الديمقراطية، في نظام أزمة معممة، ومأزق اجمالي، عائقً بوجه التراكم، ونرى اليوم في كل مكان سعيا إلى الالتفاف على الديمقراطية، وتحويلها إلى قوقعة فارغة.
لا يتخذ ذلك- حتى الآن - أشكال ديكتاتورية كلاسيكية بفعل أسباب تاريخية، ولكن الديمقراطية أصبحت بلا معنى. يكتسي ما يفعله ايلون ماسك أهمية بالغة من وجهة النظر هذه: لن يلغوا الانتخابات، بل سيدمرون دولة القانون، ويتحكمون بوسائل الإعلام، ويقيمون ديمقراطية شكلية فارغة من معناها. و روسيا أكثر النماذج تقدمًا في هذا الصدد، حيث بات نظامها متزايد الاستبدادي. لا يمكن والحالة هذه استبعاد أن يؤدي ذلك إلى ارساء دكتاتورية كلاسيكية. توجد مسألتان تصبان في هذا الاتجاه. تتمثل الأولى في منطق الريع، الذي يمثل منطقًا شبه إقطاعي: لا يشكل منطقًا يختار فيه الناس، حيث يتمتع الأفراد بالمواطنة، بل منطقًا يدفعون فيه مقابل خدمات جُعلت لا غنى عنها... وتتمثل الثانية في جمهورية الصين الشعبية. إنها رأسمالية غير ديمقراطية وهي النجاح الرأسمالي الوحيد في عصرنا. أنا غير متأكد حتى من وجود شيء مماثل للصين في تاريخ الرأسمالية. وبالتالي يقول الناس: إذا كانت مشكلتنا قائمة في التراكم، فأمامنا نموذج بلد حقق التراكم في ظل ظروف استثنائية: إنها الصين، بلد الحزب الوحيد.
أما بشأن مسألة الحروب: في الواقع، إذا كانت الكعكة تكبر بوتيرة بطيئة في هذا النظام ذي النمو المنخفض، وكان من الصعب توزيع الحصص فيه، وكان الهدف ترسيخ منطق افتراس ما تحقق فيه من قيمة قليلة، يتعين التحكم سياسيا بأكبر قدر من الحصص. عندما كانت الصين تشهد معدل نمو بنسبة 10%، لم تكن مسألة التحكم الإقليمي تكتسي أهمية. لكن عندما انخفض معدل النمو رسميًا إلى نسبة 5%، وربما في الواقع إلى نسبة 2 أو 3%، وتعهد الحزب الشيوعي الصيني بالتشغيل الكامل وتحقيق مستوى معيشة يضاهي نظيره في الغرب بحلول العام 2050، لم يعد بالوسع الاكتفاء بمعدّل النمو الداخلي.ينبغي والحالة هذه تأمين الموارد والأسواق التي لا تخضع لمخاطر المنافسة. يجب إذن الاستحواذ عليها. هذا المنطق الإمبريالي هو طريق الصين، وينطبق الأمر نفسه تمامًا على الولايات المتحدة الأمريكية.
إنها عودة إلى إمبريالية عنيفة، امبريالية أواخر القرن التاسع عشر: إذ أن الاستحواذ الحصري على الأراضي هو المفتاح، وما هوس ترامب بغرينلاند وقناة بنما إلا سعي للاستحواذ الحصري على هذه الثروات. لا يمكن القول إن الدنمارك تشكل خطرًا على الولايات المتحدة الأمريكية أو منافسًا خطيرًا لها، لكن ترامب لا يود المجازفة ويريد السيطرة الحصرية. عند التفكير بمنطق السيطرة الحصرية، تغدو المواجهة حتمية... فهل سيؤدي ذلك إلى نزاع معمم؟ إذا اعتمدنا المنطق الاجمالي الذي مؤداه بأن الحرب هي الأمر الوحيد المفيد في إعادة إطلاق التراكم، فلم لا. باتت النزاعات الإقليمية قائمة على أي حال. وتقع أوروبا في صلب المشكلة. إذا ما أصبحت القارة العجوز كعكة بسيطة تتقاسمها واشنطن وموسكو، فقد تغدو النزاعات عنيفة للغاية. قد يؤدي انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وإخضاع الاستفادة من الضمانة الأمنية الأمريكية للتبعية، إلى تمهيد طريق توسع روسيا ونشوب نزاعات جديدة في أوربا الشرقية. لم يعد ثمة اليوم أمن عالمي.
أنا لا أقول إن الناتو كان رائعًا. كان شكلاً آخر من أشكال الإمبريالية. لكن الوضع الآن مغاير إذ الأمن الوحيد الممكن هو التبعية للمتروبول والقيام بالدور المطلوب لازدهار هذا المتربول. ذلك ما يقوله ترامب للدنمارك وكندا: يقول للبلدين الحليفين: «إما أن تعطوني قطعة من أراضيكم أو أرسل قواتي»، أو «إذا أردتم العيش في سلام وراحة بال، انضموا الينا وستكونون جزءا من المركز».
ماذا عن أوروبا في هذا كله؟
لا يبدو واضحاً كيف ستستطيع أوروبا بناء شيء يوازن قوة الولايات المتحدة الأمريكية وابتزازها، لأن أوروبا تدفع ثمن نزعتها النيوليبرالية المنفلتة من عقالها: أصبحت أوروبا تعاني من عجز شديد، ومن الضعف وتراجع التصنيع. راهنت بكل شيء على تحالفها مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأصبحت اليوم في مواجهة ترامبٍ يضع المسدس على صدغها. هذا مع وجود قوة إمبريالية أخرى على أبوابها، أي روسيا، التي ستستغل أدنى خطوة خاطئة للانقضاض عليها. ولا تنتظر الصين الإمبريالية سوى استعادة سوق أوروبا.
بات الوضع معقداً، مع دينامية اقتصادية منعدمة، ومجتمعات منفلقة تماماً، وأحزاب يمينية متطرفة سائرة في صف الأميركيين أو الروس أو في صف الاثنين معاً. يبدو جليًا أن الوضع في طور انحطاط.
4 شباط/ فبراير 2024
حاوره أنطوان لاراش Antoine Larrache ويان ماليفسكي .Jan Malewski
- 1
إن الوسيلتين الرئيسيتين اللتين يجهد الرأسماليون بواسطتهما لزيادة حصتهم، أي لزيادة فائض القيمة هما:
أ- إطالة يوم العمل (من القرن السادس عشر إلى منتصف التاسع عشر في الغرب، وحتى أيامنا في العديد من البلدان شبه المستعمرة) وتقليص الأجور الفعلية وتخفيض «الحد الأدنى» المعيشي. هذا ما يسميه ماركس زيادة فائض القيمة المطلق.
ب- زيادة كثافة العمل وإنتاجيته في دائرة السلع الاستهلاكية (وقد سادت هذه الوسيلة في الغرب منذ النصف الثاني للقرن التاسع عشر). وبالفعل، فإذا سمحت زيادة إنتاجية العمل في صناعات السلع الاستهلاكية وفي الزراعة، إذا سمحت للعامل الصناعي المتوسط بأن يعيد إنتاج قيمة تشكيلة محددة من تلك السلع الاستهلاكية بثلاث ساعات عمل بدل الاضطرار إلى العمل خمس ساعات لإنتاجها، يصبح بامكان فائض القيمة الذي يقدمه العامل لرب عمله الانتقال من نتاج ثلاث ساعات إلى نتاج خمس ساعات عمل مع بقاء يوم العمل محددا بثماني ساعات. هذا ما يسميه ماركس زيادة فائض القيمة النسبي.مدخل إلى الاشتراكية العلمية -ماندل
ترجمة: غسان ماجد و كميل داغر (1980)